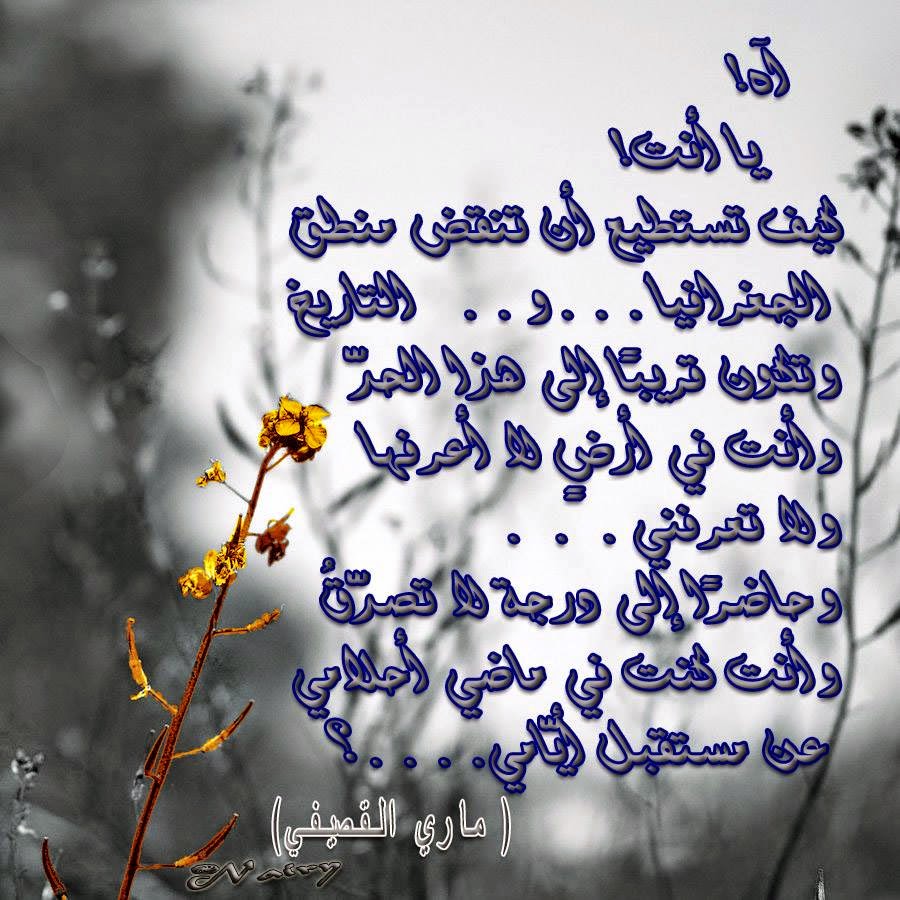الشعراء المسيحيّون والعشق وداعش
الخوف على المسيحيّين المشرقيّين لم يكن مزحة في يوم من الأيّام. وحين نشرت كتابي "الموارنة مرّوا من هنا - بألم ماري القصيفي"، كنت أعرف أنّ الخطايا التي ترتكب في الطائفة المراهَن عليها ستكون يومًا خطأ قاتلًا في حقّ الطوائف المسيحيّة الأخرى وغير المسيحيّة. ولعلّ خطيئة المارونيّ الأولى والكبرى والخطيرة أنّه لم يجرؤ يومًا على العشق، العشق البشريّ، بلا قيود أو موانع أو شروط أو مخاوف أو محاذير... العشق الطبيعيّ المجنون الذي لا يقتل الجسد ولا يحرم النفس ولا يكبت المشاعر ولا يغسل الدماغ ولا يخجل من النظر في وجه الله.
أنا لا أعرف شاعرًا واحدًا مسيحيًّا لبنانيًّا يمكن القول أنّه عشق بصدق وجرأة وشجاعة! هل تعرفون؟ اذكروا لي اسم واحد منهم أحبّ فعلًا وترك كلّ شيء ليلبّي نداء القلب! جبران النسونجيّ وحبيب لبنان؟ سعيد عقل أسير أمّه والعذراء مريم؟ الياس أبو شبكة التائه بين غلوائه وحبيبته؟ أنسي الحاج عاشق فيروز ونفسه؟ صلاح لبكي؟ فؤاد سليمان؟ ميشال طراد؟ عاصي الرحباني؟ يوسف الخال؟ أمين نخلة؟ جوزف حرب؟ مَن منهم تحرّر من صلبه على خشبة المسيح ولبنان ليقول نعم لامرأة واحدة وجد فيها المسيح ولبنان؟ أنا لا أعرف اسمًا واحدًا في هذا الوطن، فهل أجزم وأقول ولا في المشرق العربيّ كلّه؟
بين الخوف على المصير، والتأثّر بالتيّارات الأدبيّة الأجنبيّة، تلقّط الشاعر المسيحيّ بروحانيّة المسيح وجسد الوطن، فضاعت المرأة من يده وتاه هو. لتبقى القصيدة شاهدة على التشظّي والتشرذم والتفتّت بحثًا عن فردوس مفقود كان يمكن أن يكون بسهولة حضن امرأة، امرأة هي مزيج من العذراء والمجدليّة، لا واحدتهما على حساب الأخرى. ومن لا يجرؤ على عيش حبّ كهذا كيف له أن يكون مثقّفًا ثائرًا منتفضًا مقاومًا مغيّرًا؟ بل كيف يمكن أن يكون متصالحًا مع نفسه ومع العالم؟ بل كيف يمكن أن يكون نصّه أكثر من مجرّد استظهار يدرسها التلامذة أو قصيدة يشيد بها الدارسون، أو مدرسة في السبك والبلاغة والبيان يقلّدها الآخرون، أو تيّارًا شعريًّا يؤسّس لمرحلة في الأدب لا في الحياة؟
قد يقول أحدكم ولكن عند غير المسيحيّين قد يصحّ الأمر نفسه! ربّما، لكن لأسباب أخرى تتعلّق بالحريّة والانفتاح والتفلّت من الرقيب، ولأنّ غير المسيحيّ لم يشبّه نفسه بمسيح مصلوب ولم يطلب من المرأة أن تكون عذراء تشبه أمّه التي تشبه بدورها العذراء.
واليوم، في مواجهة داعش، التي وللغرابة لا تقتل المسيحيّين بل تبعدهم في عمليّة مكشوفة للفرز الطائفيّ وتقسيم المنطقة، اليوم، لا يجد الشعراء "المسيحيّون"، وإن كانوا ملحدين أو علمانيّين، سوى الدعوة إلى الجنس والعريّ والإلحاد، من دون أن يكتبوا نصًّا واحدًا يحرّك المجتمع ويقوده نحو خلاص ما. الشعر هو القائد، ولا قيادة من دون شغف أو جرأة أو تفلّت من قيود الفكر لا ملابس الجسد، وإن كان الزيّ مؤشّرًا لنوع من التفكير.
الشاعر المسيحيّ لم يرد أن يعشق سوى مريم العذراء لكنْ عينه كانت دائمًا على المجدليّة فبقي واقفًا عند باب القبر، مشاهدًا لا شاهدًا. ولم يرغب في التشبّه إلّا بالمسيح، لكنّه لم يحمل صليبًا ويتبعه إلى كهوف النسك والتبتّل فبقي قابعًا أمام مغارة الميلاد خروفًا لا راعيًا.
اليومَ، في عصر داعش والخليفة وقطع الرؤوس، لا زعيم مسيحيًّا - دينيًّا أو سياسيًّا أو عسكريًّا - يمكنه أن يطمئن المسيحيّين الذين التصقت بهم صفة الأقليّات وما كانوها يومًا. اليومَ لا شاعرَ يعشق امرأةً ويقول لها: إنت لستِ أمّي، ولستِ مريمي، ولستِ بلادي، لكن أنت امرأتي التي من أجلها تصالحت مع أمّي، وبسببها عرفت من هي مريم، وفي جسدها صار لي وطنٌ وبيت. اليومَ، لا أمل أمام الفتيات المسيحيّات سوى أن يزينّ أصابعهنّ، على مثال جدّتهنّ أليسار، بخواتم مرصّعة بحبيبات السمّ، ينتحرن بتناولها للخلاص من حياة لا شعراء فيها ولا رجال.
القارئ حين يعيد كتابة النصّ 1
الشاعر فراس الضمان يكتب تاريخ سوريا
لا يمكن أن يُكتب تاريخ المنطقة الحاليّ بمعزل عن صفحات التواصل الاجتماعيّ، فالحالات (الستاتوس) والتغريدات والصور مرآةٌ تعكس لحظة بلحظة تفاصيل حياة يوميّة، تتصارع فيها شتّى أنواع المشاعر كالحبّ والغضب والحزن، ويتنقّل فيها كلا الناشر والمتلقّي من الحبيب إلى الوطن إلى الله، مرورًا بكلّ ما يمكن أن يخطر على البال من مناسبات واحتفالات ولقاءات.
وكما في كلّ عصر أدبيّ، ثمّة من يخرج عن قوانين "القبيلة" وشروط الانصياع فيها، ليجد لنفسه لغته الخاصّة وفسحته التي تشبه مزاجه المعجون بمياه الحريّة، والممسوح بزيت التفرّد. فكيف إذا كان العصر عصر شبكة تواصل لا يخضع لقانون أو عُرف، ما يتيح لهؤلاء "الصعاليك" الجدد مكانًا يخيّلون فيه على أحصنة الثورة الجامحة، أو يركضون حفاة على رمال عطشى لإيقاع غزواتهم، أو يمارسون فيه العشق قصيدة، والشعر صيد لآلئ، والانتماء التزامًا لا إلزامًا؟
فراس الضمان أحد هؤلاء الشعراء، إن لم يكن أحد زعمائهم. شاعر يمارس الطبّ في أوقات الفراغ القليلة كما يحلو له أن يقول، تاركًا للشعر أن يحتلّ مساحة حياة، صارت منذ بدء التغيّرات السوريّة مشدودة إلى وتر موت قبيح يحصد الأصدقاء والجيران والزملاء بمنجلٍ صدئ. وهو حين يخلو إلى نفسه يحلو له أن يداوي جراح روحه بمازة الكلمات يتناولها لقمة بعد لقمة مع كأس عرق بلديّ، ناصع البياض كقلبه، صافي الدمعة، كدمعته. ومن دون أن يقصد، يكتب تاريخ بلاده بأناملَ تضرب على لوحة المفاتيح، مرّة بلطف وحنان، ومرّة بغضب ونقمة، ولكن دائمًا بصدق من لا يشبه إلّا نفسه التي تفيض حبًّا وشعرًا. وأنا التي ذقت نكهة شعره ذات صدفة فيسبوكيّة، وجدت كيف يسهل أن يدمن القارئ الجمال حين يثور، والثورة حين ترتدي زيّها الجديد. ومن هنا بدأت رحلتي في عالمه المجنون الصاخب الهادئ الحزين الساخر الشجاع المتوتّر.
سوريا والشعر
في عالم فراس الضمان الشعريّ لا مكان إلّا لسورياه وشعره المشغول بعناية طبيب يعرف أنّ كلّ خطأ ولو بسيطًا قاتل؛ وكلّ عنصر آخر، بما في ذلك المرأة، يبقى وسيلة لإيصال عشقه لبلاده وانصهاره بكلمته التي تنوء تحت ثقل حزن عتيق. كأنّ المكان لا يتّسع، على الأقلّ الآن، إلّا لجعل الكلمة سلاحًا، في زمن العنف والدماء، يدافع به عن أرضه وشعبه، كما يعرف أرضه، وكما يريد لشعبه أن يكون عليه. وما حديثه عن أمّه وأبيه وجدّه وأصدقائه الراحلين ونادلة البار والحبيبة، إلاّ ليحكي عن سوريا، وما وصفه مائدة سكره اللذيذ إلّا للتمسّك بحياة لا يراها خارج أرض بلاده، ولا يرى بلاده تعرف غيرها. يقول: عشرُ أسنانٍ/ تنبتُ/ على صمته الطويل كلّ يوم/ ومع ذلك.../ ممدّدًا كنهر/ - تحت بندقيّته المعلّقة على الجدار/ يقضم جدّي أحزانه/ بصوت غير مسموع/ غير مسموع أبدًا. فالجدّ هنا عذر للوصول إلى الحزن السوريّ المخنوق في الحناجر وتحت التراب. كأنّ الحزن قديم، سابق لما يحصل الآن. حتّى عندما يكتب عن نفسه (وهو يصف نفسه في صورته طفلًا) تأتي الهزيمة مصير طفولة معلّقة على حبال الحلم: هذا أنا/ نعم...أنا قبل سبع حبيبات و3000 ليتر من العرق البلديّ السوريّ الأصيل وانكسارين. أمّا حين يكتب غزلًا، وغالبًا هو غزل مشاكس مجنون حسيّ تبدو العاطفة فيه قلقة تائهة، فتكون سوريا هي الحبيبة، والمرأة خيالها الباهت، فيقول: طيّب...أنا ندمان! وحياة سوريا أنا ندمان، ومن اليوم ورايح رح صير أندم إنسان بالعالم... نعم، رح ضلّ ندمان من الصبح حتّى آخر الليل/ طيّب خلّيني عَضّ أصابيعك من الندم/ أمانة خلّيني.
وفي نصّ آخر يقول:
منذُ قليل قررتُ أن أصَلِّي، نعم... لأوَّل مَرَّةٍ في حياتي قررتُ أن أصَلِّي !! وبعدَ أن تحَمَّمتُ؛ وفرشتُ سجَّادةَ الصلاةِ أمامي؛ لم أجدْ قِبلةً أتَّجهُ نَحوَها؟! ، الشمالُ قذر!! الغربُ وقح، الشرقُ لئيم، الجنوبُ غدَّار !! ومن دونِ أن أدري؛ وجدتُ نفسي أقفُ أمامَ صورةِ أبي!! أبي الذي كانَ كلَّما سمعَ نشيدَ العراقِ الوطنيِّ بكى!! أبي الذي غادرَني منذُ عشرينَ عاما ًوهو يوصيني وهو على فراش الموت: لا تُغادرْ سوريا يا فراس !! مهما كانتِ الظروف لا تتركها !! صلَّيتُ أمامَ صورةِ أبي، وصارتْ دعواتي كُلّها بينَ يديّ الله الطَّيب الحنون الآن !! كانت صلاةً ساميةً نقيَّةً بيضاء !! ... بيضاءَ كثلج الزبداني وبلودان !! وكانت شامخةً... صلاةً سوريَّةً شامخةً مِن دونِ ركوع!!
شعر فراس الضمان يجعلني أسأل إن كان ما يحصل في سوريا - بعيدًا عن التوصيفات والصفات والتسميات - كان لا بدّ أن يحصل كي يعرف العالم أنّ ثمّة شعبًا يتنفّس الشعر، ويسري في عروقه الفنّ لا الدم. ليس كلّ الشعب، حتمًا، فلست من المؤمنين والمؤمنات بصفاء العرق ولا بتوزيع المواهب بالتساوي. لكن، لا بدّ لنا من قراءة جديدة لهذا الشعب الذي جاورناه (أقول ذلك كلبنانيّة الآن) ولا نعرفه حقّ المعرفة. فلا نحفظ من أسماء شعرائه إلّا من اكتسح المشهد، وتركنا في المقابل للمسلسلات الدراميّة أن تسدّ الفراغات الأخرى، ولم نسع فعلًا لنرى أبعد من الشغّيل السوري والعسكريّ السوريّ (نحن والسوريّون نتحمّل مسؤوليّة ذلك). ولم نعرف أنّ هناك سوريّين آخرين يدرسون ويقرأون ويحلمون بالحريّة والشعر والحبّ، ويتفوّقون في مجالات يصعب حصرها. من هنا يبدو لي أنّ تاريخًا تكتبه القصيدة، قصيدة فراس الضمان مثلًا لا حصرًا، والرواية والمسرح والأغنية، هو ما يجبّ أن يدرسه تلامذة المدارس ويحلّله النقّاد، وها هي وسائل التواصل تتيح لنا اليوم أن نعيد اكتشاف الآخر، كلّ آخر، بعيدًا عن الأفكار المتوارثة أو المسبقة أو المعلّبة.
اللغة
لغة فراس الضمان مضمون وصولها إلى القارئ في شكلها الأتمّ، أكانت في الشعر الموزون أو المنثور أو المحكيّ. ولكنّ الصنعة التي تبدو جليّة في سبكه اللغويّ لا تقتل عفويّة الصورة، فيبدو الشاعر كمصمّم أزياء محترف، يعرف كيف يبرز روح الفكرة وجسد الكلمة في أبهى حلّة. لذلك نراه حريصًا على تشكيل المفردات بشكل لا يسمح للقارئ بالخطأ والتعثّر، لا خوفًا على القارئ نفسه من عدم التقاط المعنى بل إصرارًا من الشاعر على عدم الإساءة إلى اللغة. بل أكاد أقول إنّه يقصد ما هو أبعد، يقصد أن يصل إلى تمام الشكل، كأنّ الحرف العربيّ لا تكتمل صورته إلّا بالحركة المناسبة الموقّعة. وأحسب أنْ لو أتيح له أن يرسم كلماته رسمًا على شاشة اللابتوب لما تردّد. ففراس الضمان لا يتهاون ولا يتساهل متى تعلّق الأمر بقصيدته، لذلك تأتي نصوصه مكثّفة، فيها المطلوب لا أكثر ولا أقلّ. ولا يصحّ أن يقول أحدكم عن شعره أنّه من نوع السهل الممتنع، فهو ليس سهلًا ولا يقرأ على عجل ولا يمكن رصد مضامينه من اللمحة الأولى. ومع ذلك فما من كلمة صعبة، ولا معنى ملتبس. بل فكرة تشرقط، ولغة تفاجئ، ومعنى يصدم، وفي النهاية نصّ يثير الدهشة. وما الشعر إن لم يكن دهشة؟ وما الشعر إن لم يكن شعر فراس الضمان؟
ومع ذلك تحتاج هذه النصوص المبثوثة عبر فضاء الافتراض إلى أكثر من هذه المقالة المقتضبة، للإحاطة بثقافة كاتبها، بحسّه المرهف، بنقده اللاذع، بسخريته السوداء، بمجونه وجنونه، بإنسانيّته، بوطنيّته، بإيمانه، بحقل مفرداته السخيّ... ولعلّ أكثر ما تحتاج إليه أن تصدر في دواوين تعيد للشعر مكانته بين أهل الفكر، وللشاعر دوره في إثارة الشغب والمشاعر. لا لأنّ عالم الفيسبوك عابر، بل لأنّ دواوين الشعراء في المكتبات تتوق إلى الاتّكاء على من يسند عمرها ويكمل مسيرتها.
مختارات من نصوص فراس الضمان
1
ماتَ أبي، ولم أبكِ !! ... احترقَتْ السوقُ القديمة في حلب، ولم أبكِ، .... سترحلُ فيروز، و لن أبكي !!.... ولكنْ، البارحة... البارحة تحديدًا، في بيت ٍحميم ٍ في طرطوس، وبينما كانت طاولةُ السهرةِ تسيرُ كالمعتاد... أنا، و لؤي الحاج صالح، وفارس حميدي، وعلاء الناصر، وغيابُ عبدالله ونوس!! وزجاجاتُ العَرَق مبعثرةٌ كأرواحنا!! تُرفَعُ كأسٌ، فتَتبَعها أربعٌ، كإوزَّة ٍوفراخها!! مقاطعُ للماغوط، ورامبو، ورياض الصالح الحسين، تعني - كالمعتاد - أنَّ النهرَ اقتربَ... اقتربَ كثيرًا من المَصَب!!.... وفجأةً، ظهَرَ صباح فخري... ظهرَ صباح فخري على شاشةِ [اللابتوب]... حفلة جار القمر في بيروت، صباح فخري، يصدحُ كالغزال!! وحسناوات بيروت، يُرفرفنَ حولَهُ كقلوبنا!!... وهنا سادَ صمتٌ طويل، [طويلٌ كشجر الحَور!!]... تَوقَّفَ النهر، ذبلَتْ سجائرنا، مالتْ كؤوسنا!! ومِن دونِ اتفاق، وبتوقيتٍ واحد ٍوقَفنا... وقفنا جميعًا، أنا... القادمُ من كروم سَلَمية ، سَلَمية الماغوط ، وعلي الجندي، ومنذر الشيحاوي!! سَلَمية التي [لسنابلها أطواقٌ من النَّمل، ولكنَّها لا تعرفُ الجوعَ أبدًا!!] .... وفارس حميدي... القادمُ من قلعةِ حلب، مِن مارع... من حقول العدس، المبلَّلة بالغبار ودموع رياض الصالح الحسين!!... وعلاء الناصر... القادمُ من حوران، من سهولِ حوران الحمراءِ كعيوننا!!... ولؤي الحاج صالح... صاحبُ الأرض، والزمان، والمكان، طرطوس... طرطوس... سعدالله ونوس، وأنور بدر، ورشا عمران، وأرواد الشامخةُ في سماء قرطاج!!... طرطوس، حبَّةُ الزيتون... حبَّةُ الزيتون التي بدمعةٍ واحدةٍ تُصبحُ خمرةً !!... وغيابُ عبدالله ونوس يضُمُّنا... يضمُّنا جميعًا!!... وقفنا، ودموعنا الطويلةُ السمراء، بصوتٍ واحدٍ كانت تقول: أنا سوريا ... أنا سوريا، الكعبةُ الجريحةُ البيضاء!!... أنا سوريا، الممتلئةُ نعمة ً!! .... أرفضُ أن أموت، أرفضُ أن أنتهي إلى المَصَبّ!
2
...رسالة......
عبد الله ونوس ...
أيها الشرف المستباح كالتاريخ
لا تأسف على دمك المقفى
فقد ثأرنا لك
وجعلنا الشعر حرّا !!
عبد الله ونوس ...
أيها الشرف المستباح كالتاريخ
لا تأسف على دمك المقفى
فقد ثأرنا لك
وجعلنا الشعر حرّا !!
3
يشربُ الخمرةَ مع الريح !!
يكتبُ القصائدَ على الجدران
يوزّعُ السكاكرَ على المرضى
و الفستقَ
على ممرضاتِ الطابق ِ الخامسِ!
في المشفى الوطنيّ في طرطوس
كانَ الجميعُ قد قضموا مِن قلبهِ
و ابتسموا
أمامَ عينيهِ الضاحكتَين!
و ذاتَ صباح ...
صباحٍ ماطرٍ حزين
كانَ الرجُلُ الأبيضُ الطويل
بجيوبهِ الملأى
و عينيهِ الباكيتين
الباكيتين .... الباكيتين!
مُمَدَّدا ً
في ثلاَّجةِ مشفًى آخر!
يكتبُ القصائدَ على الجدران
يوزّعُ السكاكرَ على المرضى
و الفستقَ
على ممرضاتِ الطابق ِ الخامسِ!
في المشفى الوطنيّ في طرطوس
كانَ الجميعُ قد قضموا مِن قلبهِ
و ابتسموا
أمامَ عينيهِ الضاحكتَين!
و ذاتَ صباح ...
صباحٍ ماطرٍ حزين
كانَ الرجُلُ الأبيضُ الطويل
بجيوبهِ الملأى
و عينيهِ الباكيتين
الباكيتين .... الباكيتين!
مُمَدَّدا ً
في ثلاَّجةِ مشفًى آخر!
4
اتفقنا على قُبلةٍ...
قبلةٍ واحدةٍ خلفَ المقهى
قبلةٍ سريعةٍ
في الزاويةِ المظلمةِ خلفَ المقهى !!
و لكن ....
ثوبُها المَطَريُّ الخفيف
و السحَّابُ السريعُ على الظَهر
و أصابعي التي تتكاثرُ في الظلام !!
يجعلونَ الإتّفاقَ
-كما هو دائمًا-
حِبرا ً ....
حبرا ً أبيضَ على الصدر!
قبلةٍ واحدةٍ خلفَ المقهى
قبلةٍ سريعةٍ
في الزاويةِ المظلمةِ خلفَ المقهى !!
و لكن ....
ثوبُها المَطَريُّ الخفيف
و السحَّابُ السريعُ على الظَهر
و أصابعي التي تتكاثرُ في الظلام !!
يجعلونَ الإتّفاقَ
-كما هو دائمًا-
حِبرا ً ....
حبرا ً أبيضَ على الصدر!
5
مرَّ عامان ...
وما زالت دمشقُ
فراشةً...
تنبُضُ بينَ كَفَّيهِ المتلاصقتين !!
مَرَّ عامان ...
و مازالَ
وما زالت دمشقُ
فراشةً...
تنبُضُ بينَ كَفَّيهِ المتلاصقتين !!
مَرَّ عامان ...
و مازالَ
- رغمَ تأنيبِ الغرباءِ في زنزانتهِ-
يرفضُ ...
أن يَبسطَ كفَّيهِ نحوَ السماء . !!
يرفضُ ...
أن يَبسطَ كفَّيهِ نحوَ السماء . !!
6
اليوم صباحًا اشتريت بطاقة يانصيب، سَحب رأس السنة!! ولأني كنت حامل أكياس كتيرة - عدَّة السَكرة اليوم!! - وقعتْ بطاقة اليانصيب من جيبي من دون أن أنتبه!! وفجأة نكزني من ظَهري شاب ثلاثيني رَثّ الثياب، بائس المنظر!! وقال لي: يا أبو الشباب... خوذ بطاقة اليانصيب هذه... هذهِ إلَكْ... وقعتْ منَّك هلَّق!! فكانَ اندهاشي كبيرًا من الموقف، وسألتْ الشاب مباشرةً: شكرًا لكَ ...بس فيني أعرف ليش ما أخذتْ أنتَ البطاقة؟؟... شو إللي منعَكْ؟!...مع كامل احترامي لكَ طبعًا!! وهنا... أجابني الشاب قائلًا: يا أبو الشباب شَكلَكْ مو شَكل واحد ممكن يربَح علكة! فصار اندهاشي أكبر.. وأكبر !! ، وسألتهُ قائلًا: مالسبب يا أخي؟؟ ... شو شفت مني حتى تحكي هيك؟؟ أجابني الشاب وهو يبتعد أمامي على الرصيف: عيونَك ... عيونَك خَرجْ بكي يا أبو الشباب... خرج بكي بس!!
7
في اللَّوحةِ ...
أخطِىءُ في المَنظور !!
في الروايةِ ...
أخطِىءُ
في البَطَل ِ
و المدينةِ التي ستَجرحُني في أيلول !!
في المقطوعةِ ...
في لحظةِ استدعاءِ البيانو !!
في القصيدةِ ...
دائما ً في القصيدةِ
لا أخطىءُ أبدا ً
في جَعلكِ تَبتَلِّين !!
نعم ...
تَبتَلِّينَ حتى العَضَّةِ الخفيفةِ على الشفةِ السفلى !!
بالضبط
كما سيَحدثُ الآن !!
أخطِىءُ في المَنظور !!
في الروايةِ ...
أخطِىءُ
في البَطَل ِ
و المدينةِ التي ستَجرحُني في أيلول !!
في المقطوعةِ ...
في لحظةِ استدعاءِ البيانو !!
في القصيدةِ ...
دائما ً في القصيدةِ
لا أخطىءُ أبدا ً
في جَعلكِ تَبتَلِّين !!
نعم ...
تَبتَلِّينَ حتى العَضَّةِ الخفيفةِ على الشفةِ السفلى !!
بالضبط
كما سيَحدثُ الآن !!
جان الهاشم في قراءة لروايتي للجبل عندنا خمسة فصول
ماري القصيفي في رواية الانسحاق والأمل تحكي ماري القصيفي، في روايتها «للجبل عندنا خمسة فصول» (دار سائر المشرق)، الحرب اللبنانية في أحد وجوهها، حرب الجبل في ثمانينات القرن الماضي، بين الموارنة والدروز، وهي انتهت بتهجير المسيحيين من تلك المنطقة التي تعايشوا فيها معاً زمناً طويلاً، قبل أن تبدأ حروبهم وتتواتر منذ ستينات القرن التاسع عشر. وهذا التواتر أعطى الكتاب عنوانه، إذ صار لأبناء الجبل فصل خامس متكرّر يضاف إلى فصول السنة الثابتة المتكرّرة بانتظام، هو فصل الجنون: «ففي الفصل الخامس من فصول تلك السنة في الجبل اللبناني، فصل الجنون الذي لا ينفكّ يعود...» (ص 187). وإن تكن الشخصية الرئيسة في الرواية هي الراوية سلوى بو مرعي، إلا أن بطلة الرواية من دون منازع هي «الحرب اللبنانية» بكل صورها البشعة... تتفرَّغ سلوى بو مرعي لكتابة ذكرياتها عن حرب الجبل، وقصة تهجير عائلتها من قريتها، مع سائر المسيحيين في سائر القرى، إلى دير القمر. ليلة التهجير رسمت مستقبلها، وحفرت في نفسها عميقاً حتى باتت وقائعها راسخة في قلبها، وهي تريد أن تبوح بها لكي «تزيل حملاً ثقيلاً كالجبل...» (ص 12). في تلك الليلة هربت العائلة من بلدتها عين يوسف سيراً على الأقدام، ما عدا الأب الذي رفض المغادرة ولازم منزله حيث قُتِل. لكن أخاها التوأم سليم، المختلّ عقلياً، نسي الراديو وأصر على العودة للإتيان به، فطلبت منها أمها أن تعود معه وأكملت طريقها فارَّة. تخلَّت عنهما الأم، وتخلّفا عن ركب النازحين، لكن سليم، الذي يعرف الدروب جيّداً، يقودها وصولاً إلى دير القمر حيث تجمّع النازحون، وحوصروا إلى أن كان الخلاص بإخراجهم من هناك بعد أشهر إلى بيروت وسائر المناطق. وينتهي بها الأمر عاملة في دير الصليب، مصح المجانين، الذي أُدخل إليه شقيقها سليم، واختارت العمل هناك لأنها أرادت أن تلازمه لقربها منه ولتعلّقه بها. وتبدأ أحداث الرواية الفعلية (زمن الرواية) من هناك، من مصح دير الصليب حيث حاولت أن تنسى ما حدث، لكنها لم تستطع. تقرّر أن تكتب عن تلك المرحلة بناء على نصيحة ثلاثة: مي ابنة خالتها، والصديقة الوحيدة التي بقيت لها، ودانيال العشيق المفقود، وفادي الطبيب في المصح. «اكتبي عنها يزُل الألم وتبقَ الذاكرة» (ص 18). وانتقلت إلى بحمدون لتتفرّغ فيها للكتابة. وراحت تلملم عن ألسنة الناس فيها ذكرياتهم عن وقائع مرحلة سقوط البلدة، والنزوح عنها. أخذت عن جورج ابن صاحب البيت الذي استأجرته، وقرأت أوراق طبيبة طوارئ سويسرية، تدعى جوزيان أندريه، عملت في خلال الحرب في بحمدون ودوّنت يومياتها فيها. وما كتبته سلوى يذكّر القارئ بتلك المؤلفات عن حرب الجبل، التي روت الأحداث من زاوية واحدة، وهنا من وجهة نظر شابة مسيحية، معجبة ببعض زعماء طائفتها، وغاضبة على أكثرهم لأنهم لم يعرفوا كيف يقودون الحرب. مع أنها في ما كتبت حمّلت الجميع، مسيحيين ودروزاً مسؤولية الحرب وبشاعاتها. المسيحيون حركشوا، والدروز انتقموا والمواطن دفع «ثمن غباء المسيحي وغضب الدرزي، والغباء قاتل كالغضب» (ص 128). وتعود سلوى إلى زمن الأحداث الحقيقي. ما جرى في دير القمر. لم تنم مع المهجّرين في مكان تجمّعهم. هي كرهتهم، وأرادت الابتعاد عن أمّها التي تكرهها معتبرة أنها أخذت كل العقل ولم تترك شيئاً لأخيها التوأم سليم. نامت في الكنيسة حيث قيل إن ثلاثة رجال اعتدوا عليها ومارسوا الجنس معها، فحملت بذلك العار. وتتحرّك أحداث الرواية بثقل وتباطؤ وتشابه وتكرار، كأن الكاتبة تعمّدت ذلك لكي تبرز تلك الدوامة التي يدور فيها المسيحيون والدروز في فصل الجنون الذي لا يني يتكرّر. لم تسلم سلوى من كلّ تلك الأحداث، هي وقعت ضحيتها فتشوّهت نفسيتها بأبشع ما يكون. حمّلها الناس عاراً لم تحمله أساساً، وقد أوضحت ما جرى لها مع الرجال الثلاثة، وما باحوا به لها. الأوّل أراد وهو معها أن يشعر «بأنّ الحرب لم تقتل فيّ كل شيء...»، والثاني أراد أن يتذكّر أمه وهو يغفو على صدرها، والثالث بكى وهدّدها: «إن عرفت أنك أخبرتِ أحداً أنني بكيت قتلتك بلا شفقة ولا رحمة...» (ص 92). حالات ربما تنتاب من انقاد للحرب غصباً عنه، وربما تكون حاجاتها هي نفسها، لأنها حاولت مقاومة الحرب، وافتقدت الأم هي المكروهة من أمها. وينتهي القسم الأول من الرواية، مع ما توصلت سلوى إلى تدوينه، لأنها ستصاب بمرض السرطان وتموت قبل أن تكمل ما بدأته. في القسم الثاني تتولّى مي، ابنة خالتها، إكمال ما بدأته، أو بالأحرى إيضاح كل ما ورد في أوراقها من مواقف وأخبار. وتتحول في القسم الثاني إلى راوية بدورها ترى إلى ما أوردته سلوى من منظار آخر. وهنا تتكشّف لنا براعة الكاتبة في لعبة الإيهام، مع ما نكتشفه من وقوع سلوى في حالة الإسقاط (projection) المعروفة في الطب النفسي، بوجهيها: «الإسقاط النفسي»، وفيها تتلبَّس شخصيات الآخرين وتتبنى مواقفهم، و «الإسقاط التحويري» وفيها تعكس حالاتها النفسية على الآخرين. تروي مي، وهي كما رأينا وجه آخر من وجوه سلوى: «وضعتني كتابات سلوى أمام حياتنا كلّنا، ففيها ما حصل معي وتبنّته هي، وفيها حكايات رويتها لها (...) وفيها قصص أقربائنا من المهجّرين (...) وفيها خصوصاً أوراق أنطوني خير الله وجوزيان الطبيبة السويسرية (...) «ظنّاً مني أنني أساعدها (سلوى) في التعلق بالحياة كما فعل انطوني، والإيمان كما تحدّثت عن مفعوله جوزيان» (ص 263). ونكتشف أن سلوى هي المجنونة في مصح دير الصليب، وليس شقيقها سليم. ونكتشف أن دانيال، الذي تروي سلوى قصة غرامياتها معه، وحبها له، ليس سوى زوج مي نفسها. تعيش سلوى إذاً في أوهامها وكوابيسها، لكن ماري القصيفي، عرفت كيف تقودنا معها على طريق الإيهام، لتكشف لنا في النهاية حقيقة الأمور. طوال الرواية بدت سلوى امرأة مسيحية، تعيش هواجس مسيحيّي الشوف ومخاوفهم. وإذا سلَّمنا بأن مي شكلت عقلها ووجدانها، نجد أن هذه الأخيرة، أصرت مع زوجها دانيال على بناء العائلة، وعلى العمل على الثبات في الوطن، معبّرة عن حنينها إلى أيام المحبة والاختلاط في الجبل، آملة في إحياء ذلك يوماً ما، على رغم بقائها مهجّرة بعيداً من أرض الشوف. عاشت مي الحرب والهواجس، وحمَّلت الجميع، مسيحيين ودروزاً مسؤولية الحرب، لكنها تحلَّتْ بالأمل، استمدّته من دانيال، الزوج المرمِّم وباني الوطن المأمول معها. بذلك تصبح سلوى الإنسان اللبناني المصاب بالانفصام بعدما مزّقته الحرب ما بين اليأس والأمل، ما بين الموت والحياة، ما بين الحلم والواقع. في عمق مأساتها ظلت تأمل بوجود حبل خلاص يعيد الرحمة والمحبة إلى القلوب، كتلك المرأة الدرزية بالوشاح البيض، التي روت عنها أنها أنقذتها مع شقيقها سليم أثناء فرارهما، وكما يقول دانيال لزوجته، فإن سلوى «في نصوصها عاشت وعشقت وانتقمت وتطهَّرت، وتمسّكت، في حديثها عن المرأة الدرزية التي سمّتها عذراء الجبل، بحبل خلاص ينقذها من الحقد بالرغم من الأذى الذي تعرَّضت له!» (ص 312). وهذا الأمل يحدو الكثيرين على العودة إلى الجبل. لكن ما هو قائم حتى اليوم في الوقائع والنفوس يبقى معوّقاً أساسياً. وربما بسبب ذلك، وما حدث لها، وما تعيشه من تردّد وتمزّق وخوف، لاذت سلوى بالجنون لأنّ «الجنون الحقيقي أبعد ما يكون عن الغباء، وأكثر براءة من أن تلصق به جرائم الحرب، لأنه أجمل من الحقد، وأطهر من الشرّ، وأعمق من المعرفة...» (ص 315). «للجبل عندنا خمسة فصول» سجلّ الماضي وصورة الحاضر وهاجس المستقبل ومخاوفه، باللغة المنسابة ما بين السرد البسيط العادي، والتعبير الوجداني العميق المقارب الشعر، هي رواية الضياع والتمزّق والانسحاق، وفسحة أمل تبقى مفتوحة على كلّ الاحتمالات. الحياة/جان الهاشم الجمعة 11 تموز 2014 |
سلوى بوقعيقيص التي ماتت لتحيا
لم أعرف سلوى بوقعيقيص المحامية الليبيّة والناشطة للدفاع عن حقوق الإنسان إلّا عندما عرفت بخبر اغتيالها على صفحة الفيسبوك الخاصّة بابنة عمّها نادية Nadia Bugaigis. لكنّي الآن أكاد بأجزم أنّني كنت أعرفها.
حين سقط حكم معمّر القذافيّ في ليبيا، كتبت يومها: الآن سنرى أنّ في تلك البلاد شعبًا وسنعرف من هو وكيف يفكّر وماذا يرتدي وكيف يعيش... قبل ذلك كنت شخصيًّا قد نسيت، أمام وهج الإطلالات الباذخة لرؤساء الدول العربيّة وزعمائها وملوكها وأمرائها، أنّ خلف الأضواء المخادعة شعوبًا يريدون لها أن تنطفئ بصمت، ويريدون منّا أن ننساها.
سلوى السائرة إلى موتها بثقة الشجعان الذين يعرفون مصائرهم ارتسمت أمامي صورةً مضيئة لشعب تضجّ الحياة في عروقه، وتجري الحريّة في دمه، فقلت لنفسي وأنا أرى إلى وجهها الجميل، وأناقتها اللافتة، وشخصيّتها الفذّة، أنّ هذه المرأة ليست غريبة عنّي، لأنّها تشبه الجمال والحقّ والخير والحريّة والشجاعة.
ومذ قرأت خبر موتها/ الجريمة، خبر اغتيالها/ الفضيحة، وأنا أبحث عن أخبارها عبر شبكة الإنترنت، لعلّني أعرف عنها أكثر، وأقترب من عالمها أكثر. لكن ما أجده يوميًّا، يؤكّد لي أن ليس في جريمة اغتيالها ما يفاجئ: كأنّ قدرَها أن تكون ثائرة، وقدرَ تلك البلاد أن تبقى غارقة في الجهل والتعصّب والقتل. وخارج إطار الغرائز التي تتحكّم بمصائر العقول والقلوب، لا يبدو ثمّة أمل يلوح في أفق عالمنا القبيح.
لكنّ صوتًا ما يهمس في داخلي - وأنا أرى إلى صور تلك المرأة - أنّ موتها أحياها عندي، فلماذا لا تكون فيه حياةٌ لأرضها وناسها؟ هل هي رومانسيّتي المعتادة توحي لي بأنّ فرحًا سينبت من تربتها، وأنّ ابتسامة ستشرق من بين دموع أهلها وعائلتها ومحبّيها؟ أم هي ثقتي بأنّ الأرض التي أنجبت سلوى، ثمّ شربت دمها، وضمّت جسدها، كانت تستحقّ أن تبقى تلك المرأة الشجاعة فيها، وألّا تهجرها وتهاجر منها، وأن تواجه الموت كلّ يوم من أجلها؟
وأكاد أجزم وأنا أراقب عينيها ونظرة العزم والتصميم فيهما، كما تبدو في صورها كلّها، بأنّ تلك المرأة واجهت قاتليها وهي تبتسم لأنّها ستضع بموتها نقطة نهائيّة لدرس وحيد أرادت أن يتعلّمه أولادها منها وهو درس الكرامة والشرف والشجاعة. وبعد ذلك لا خوف عليهم ولا على أترابهم.
Subscribe to:
Posts (Atom)